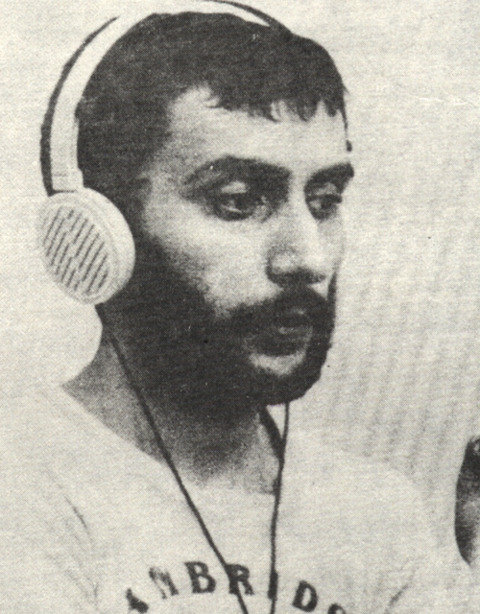عزيزتي، فيروز..
*أعرف كم ضجرت، و عانيت من مناجاة البعض لك هذه الأيّام، بعد أن تركوك شريدة آذان حجريّة لفترة ليست بالقليلة، أعرف أيضًا انك تركت فنًّا ليعيش، ليبقى دائمًا شغف الآذان الشابّة، و القلوب الصغيرة، التي يلمسها الحب لأول مرة، بالصيف و الشتا على حدٍّ سواء، ليس كما يقصر -المراهقين الجدد- صوتك على موسم الشتاء فحسب، في سكون الليل و سهر الليالي، و صوت يسعد صباح اللي يسمعك..
سأُطيل عليك إذًا، و عليك الخضوع للمناجاة..
فلتسمحي لي بدايةً أن أقتبس من حقوق ملكيّتك الصوتيّة "أهواك بلا أمل"، هكذا عرفتُ عشقها دائمًا، هكذا كانت تعطيني أملًا في الحياة اكثر ممّا كانت تجود على حبنا به الحياة،
لقد تربّيتُ تربيةً دينيّة، في أسرة مسلمة كاثوليكيّة الطباع.. وسط مجتمع آرثوذكسيًّا متزمّتًا في نفاقه، و هكذا عرفت الحب، حُبًا طاهرًا، نقيًّا..
طاهرًا، نقيًّا، نعم.. هنا مربط الفرس، هذا السؤال الذي طالما حاولت جاهدًا للحصول على إجابته، ما هو مفهوم الطهارة و النقاء في حبّي لها؟
-لا شئ، كل الأصابع تُشير إلى مابين أرجلنا -عرفته دائمًا مصدر الحياة، و تعلّمته مصدر الموت-، و أعيننا تكاد تخرق مُقلتيها لتنظر إلى ما بين فصّي دماغنا.
لم يتسنَّ لنا أن نعرف الظروف التي مات فيها ابن ستالين إلا من خلال مقال نشرته مجلة (السانداي تايمز) عام 1980. فبعد أن أسرهُ الألمان خلال الحرب العالمية، أُدخِل في معسكر الاعتقال نفسه مع ضباط إنجليز أسرى. كانت مراحيضهم مشتركة في المعسكر وكان ابن ستالين يتركها دائماً متّسخة. والإنجليز، لم يكونوا يحبون رؤية مراحيضهم ملطّخة بالبراز، حتى ولو كان ذلك البراز يخصّ ابن الرجل الأكثر نفوذاً في العالم آنذاك. كانوا يلومونه على ذلك فاستاء منهم. ثم عاودوا تأنيبه وأجبروه على تنظيف المراحيض. فغضب ثم تخاصم وتعارك وإياهم، وطلب في النهاية مقابلة آمر العسكر. كان يريده أن يحكم في نزاعهم لكنّ الألماني كان أكثر اعتزازاً بنفسه من أن يتجادل بخصوص البراز. فأطلق ابن ستالين شتائم روسيّة شنيعة ثم انقضّ باتجاه الأسلاك الشائكة المحيطة بالمعسكر والمزوّدة بتيار من التوتّر العالي. ترك نفسه يتهاوى فوق الأسلاك. وجسده الذي لن يلوّث المراحيض البريطانية بعد الآن، بقي معلّقاً هناك.
-و بقي جسدي معلّقاً في تيّار أسلاك معسكرها الشائكة-
لم تكن حياة ابن ستالين سهلة، فقد أنجبه والده من امرأة كان كل شيء يؤكد بأنه سيقتلها يوماً ما. كان ستالين الابن إذاً ابناً للإله (لأن أباه كان جليلاً وكأنه إله) وملعوناً في الوقت نفسه من الإله. كان الناس يهابونه لسببين: الأول، لأنه كان بإمكانه أن يؤذيهم بسلطته (فهو على كل حال ابن ستالين) وبصداقته (لأن الأب كان يمكنه معاقبة الصديق بدلاً من الابن المنبوذ).
في بداية الحرب أسرهُ الألمان وسجنوه إلى جانب أسرى ينتمون إلى أمة كان يشعر نحوها دائماً بكره عميق وجامح بسبب تحفظّها الغريب. وفوق ذلك كان يتهمونه بأنه وسخ، هو الذي كان يحمل فوق كتفيه المأساة الأكثر عظمة التي قُدّر لها أن توجد (كان في الوقت نفسه كأنه ابن إله وملاكاً ساقطاً) فهل يجب أن يُدان بسبب أشياء غير عظيمة (لا تخصّ الله والملائكة) وإنما بسبب البراز؟ هل المأساة الأكثر عظمة والمأساة الأكثر ابتذالاً هما قريبتان بهذا الشكل المدوّخ؟ قريبتان بشكل مدوّخ؟ هل يمكن إذاً للتقارب أن يُسبّب الدُوَار؟
بالطبع، غداً عندما سيقترب القطب الشمالي من الجنوبي إلى حد التلامس تقريباً، فسيختفي الكوكب حينها وسيجد الإنسان نفسه في فراغ مدوّخ مما يجعله يستسلم لإغواء السقوط.
فإذا كانت النعمة واللعنة شيئاً واحداً، إذا لم يكن هناك فرق بين العظيم والحقير، إذا كان بالإمكان إدانته بسبب البراز، فإن الوجود الإنساني يفقد معناه ويصبح ذا خفّةٍ لا تطاق. عندها ينقضّ ابن ستالين باتجاه الأسلاك الشائكة المكهربة، لكي يرمي هناك بجسده، كأنما على كفّة ميزان، فتصعد الكفة المدفوعة بالخفّة غير المتناهية لعالم صار بدون أبعاد.
ابن ستالين قضى في سبيل البراز. ولكن الموت في سبيل البراز ليس موتاً مجرّداً من المعنى. فالألمان الذي ضحوا بحياتهم من أجل توسيع إمبراطوريتهم أكثر تجاه الشرق، والروس الذين ماتوا لكي تمتدّ سلطة بلادهم أكثر صوب الغرب. أجل، كل هؤلاء ماتوا من أجل بلاهة، وموتهم مجرّد من أي مغزى عام. أما موت ابن ستالين فكان بالمقابل، الموت الميتافيزيقي الوحيد وسط البلاهة العالميّة للرحب.
عندما كنت صغيراً، وحينما كنت أتصفح كتاب العهد القديم الذي أعدّ للأطفال والمزيّن بصور رسمها غوستاف دوريه، كنت أرى الرب فيها طائراً فوق غيمة. كان رجلاً عجوزاً له عينان وأنف ولحية طويلة. وكنت أقول في نفسي إنه ما دام له فم فيفترض به أن يأكل، وإذا كان يأكل فهذا يعني أن لديه أمعاء. ولكن هذه الفكرة كانت ترعبني في الحال. ومع أني كنت من عائلة ملحدة، فإنني كنت أشعر بأن هذه الفكرة المتعلقة بأمعاء الله، فكرة تجديفيّة.
ومن دون أي إعداد لاهوتي كان الطفل الذي كنتهُ آنذاك يفهم بشكل عفويّ أن هناك تناقضاً بين الدونيّات والله. وكنت أفهم بالتالي هشاشة الفرضيّة الأساسية لعلم الإناسة المسيحي والتي تقول بأن الإنسان خُلق على صورة الله ومثاله.
كان (الغنوصيون) القدامى يعون هذه المسألة بالوضوح ذاته الذي كنت أراها فيه لما كنت في الخامسة من عمري. ولكي تُحسم هذه المسألة اللعينة، كان (فالنتين)، وهو أستاذ كبير للغنوصية في القرن الثاني، يؤكد أن المسيح كان (يأكل ويشرب ولكنه لم يكن يتغوّط).
البراز إذاً هو مسألة لاهوتيّة أكثر صعوبة من مسألة الشر. فالله قد أعطى الحريّة للإنسان وبذلك يمكننا أن نسلّم بأن الله ليس مسؤولاً عن جرائم البشر.
في القرن الرابع، كان القديس جيروم يرفض جذرياً أن يكون آدم وحوّاء قد تمكّنا من ممارسة الحب عندما كانا في الجنّة. خلافاً لذلك، كان جان سكوت إريجين وهو عالم لاهوتي شهير في القرن التاسع يسلّم بهذه الفكرة. ولكن حسب رأيه، كان بإمكان آدم جعل عضوه ينتصب بالطريقة نفسها تقريباً التي يرفع فيها ذراعه أو ساقه، إذاً ساعة ما يشاء وكيفما يشاء. ولا يتبادر إلى أذهاننا أن هذه الفكرة تخفي وراءها الحلم الأبدي للرجل المسكون بهاجس العجز الجنسيّ. إن لفكرة سكوت إريجين معنى آخر. إذا كان عضو الذكر يقوى على الانتصاب بمجرّد إيعاز من الدماغ، ينتج عن ذلك أن بإمكانه الاستغناء عن الإثارة. ذلك أن العضو لا ينتصب نتيجة لاهتياج المرء بل لأنه يأمره بذلك. كان هذا اللاهوتي الكبير يعتقد أن الشيء الذي لا يتفق والجنّة ليس الجماع ولا اللذّة التي تعقبه. إنما الشيء الذي لا يتفق والجنة هو الإثارة. فلنحفظ هذا جيداً: كانت اللذة موجودة في الجنة لا الإثارة.
نستطيع أن نجد من خلال نظرية سكوت مفتاحاً لتبرير لاهوتي (وبكلمة أخرى مفتاحاً لربّانيّة) البراز. طيلة الفترة التي سمح للإنسان فيها أن يسكن الجنة، إما أنه (تماماً كالمسيح حسب نظرية فالنتين) لم يكن يتغوّط، وإما أن البراز لم يكن يُعتبر شيئاً كريهاً، وهذه الفرضية أكثر قابليّة للتصديق. حين طرد الله الإنسان من الجنة، أوحى له بطبيعته النجسة وبالقرف. وأخذ الإنسان يستر ما كان يُشعره بالعار، وما أن أزاح الحجاب حتى بهره ضوء عظيم. إذاً بعد أن اكتشف الإنسان الدَنَس، اكتشف في الوقت ذاته الإثارة. فمن دون البراز (بالمعنى الحرفي والمجازي للكلمة) لما كان الحب الجنسي كما نعرفه: تصاحبه دقّات في القلب وعمى في الحواس.
إذا كانت كلمة براز يُستعاض عنها حالياً في الكتب بنٌقط، فهذا ليس لأسباب أخلاقية. يجب ألا نذهب إلى حدّ الادعاء بأن البراز شيء منافٍ للأخلاق! فالخلاف مع البراز خلاف ميتافيزيقي. هناك أمر من أمرين: إم أن البراز شيء مقبول (إذاً لا تُقفلوا على أنفسكم بالمفتاح وأنتم في المراحيض!) وإما أن الطريقة التي خُلقنا بها تُثير جدلاً.
ينتج عن ذلك أن الوفاق التام مع الكائن يتّخذ مثاله الأعلى عالماً يُنتفى منه البراز، ويتصرّف كل واحد فيه وكأن البراز غير موجود. هذا المثال الجمالي يُدعى (الكيتش).
كيتش هي كلمة ألمانية ظهرت في أواسط القرن التاسع عشر العاطفي، ثم انتشرت بعد ذلك في جميع اللغات. ولكن استعمالها بكثرة أزال دلالتها الميتافيزيقيّة وهي: كلمة كيتش في الأساس نفي المُطلق للبراز. وبالمعنى الحرفي كما بالمعنى المجازي الكيتش تطرح جانباً كل ما هو غير مقبول في الوجود الإنساني.
*أو هكذا حدّثنا ميلان كونديرا، روايته "كائن لا تحتمل خفّته"، التي أهدتها لي لسبب ما، لم تعرفه، هي!
فلندأ إذًا من البداية "بداية كل شئ"، قبل 13.8 مليار سنة من تلك الحظة التي صعق فيها جسدي تيّار أسلاك معسكر اعتقالها، الكون لم يزل في طور الانفجار، الذي تلاه مباشرة انتحار أطنان المليارات من المادة المضادة لتتيح الفرصة أمام الباقي من قريناتها من المادة العاديّة المُتبقية من تلك المذبحة التي أنتجت ذلك الضوء الساطع في جنبات الكون و من بعدها النجوم فالكواكب فالحياة!
تتكون أجسادنا من 38% من نفس تلك المواد الناجية المكوّنة للنجوم.. هناك كانت التضحية الأولى، الإنقراض الشبه-جماعي الأول الذي عرفه كوننا، من أجل "الحياة"، هناك أول حياة تولد من رحم الموت، قبل أن يخلق المجتمع موتًا من فرج الحياة،
و هناك كانت بداية حكايتي معها، حيث البراز هو أحد آهم مكوناتها، بعيدًا عن هراء "الكيتش" و غوغائية الطهارة و النقاء..


.jpg)